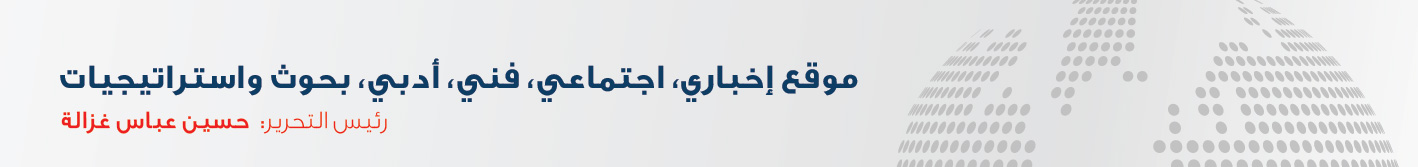في زوايا دمشق القديمة، حيث لا يزال صدى الماضي يتردد بين الحجارة العتيقة، تحكي الجدران قصصاً عن أيديٍ كانت تمسح بكل حب تراب المدينة. أيدي السقائين الذين كانوا يبللون الشوارع عند الفجر، وأيدي المبيضين الذين يحولون النحاس إلى مرايا، وأيدي الطرابيشيين الذين يصنعون من الصوف تيجاناً للرؤوس.
السقا: آخر من عرف طعم العطش
كان السقا يحمل قربة الماء كقلبٍ نابض على ظهره، يغسل دروب المدينة قبل أن تستيقظ، كأنه كاهنٌ يؤدي طقوساً مقدسة. اختفت تلك الظلال مع وصول مياه عين الفيجة، لكن ظل السؤال: ألم تكن مياه السقا أبرد؟ ألم تكن قربته أكثر رحمةً بالعطشى؟
المبيض: ساحر النحاس
في حارة الشعلان، كان آخر المبيضين يقف أمام تنوره ككاهن نار، يحرك جسده في رقصةٍ مع القصدير الساخن. حركاته كانت أشبه بسيمفونية صامتة، كل ضربة فرشاة لحناً في سيمفونية النحاس الأصفر. الفنان زهير عبد الكريم جسده في “الدغري”، لكن من يذكر الآن صوت احتكاك الخيش بالقدور؟
الطرابيشي: صانع التيجان الشعبية
في محله الضيق، كان الطرابيشي يحني ظهره على قوالب النحاس كفنانٍ ينحت تماثيل للرؤوس. الطربوش لم يكن مجرد غطاء رأس، بل شهادة اجتماعية. الفنان فهد كعيكاتي جسد “أبو فهمي” الخياط، لكن من يتذكر اليوم صوت مكابس الطرابيش؟
الداية: قابلة الأجيال
بأيدي تعرف أكثر من أي طبيب، كانت الداية تستقبل الأرواح الجديدة إلى العالم. الفنان نبيل خزام وهدى شعراوي جسداها، لكن من يذكر الآن رائحة الزيت الساخن الذي كانت تمسح به بطون الحوامل؟
الندابة: شاعرة الموت
صوتها كان آخر هدية للميت. يارا صبري جسدت الندابة في “الحصرم الشامي”، لكن من يسمع الآن تلك المراثي التي كانت تذوب في هواء المقابر؟
الكراكوزي: ظلال على الحائط
الكركوزاتي كان سينما الفقراء، يحرك دمى الجلد بأصابعه ليحول جدار المقهى إلى عالم. اليوم نضحك على ميمات الإنترنت، لكن هل ضحكنا كضحكنا على “عواظ” وهو يصفع “كركوز”؟
المصوراتي: مهندس الحياة الصغيرة
المصوراتي الخارجي بكاميرته السحرية، الدومري الذي يوقظ الفوانيس كأنه يضيء النجوم، المخرز الذي يخيط الصيني بخيط الأمل، اليهودي العتيق صاحب النداء الشعري “يللي عنده تخوتة”… كلهم كانوا مهندسين للحياة اليومية.
البيطار: آخر الفرسان
كان يثبت الحدوة بحركات دقيقة، كأنه يصلي من أجل الحصان. اختفى مع اختفاء صهيل الخيول من شوارع دمشق، تاركاً وراءه سككاً حديدية بلا طرقات.
اليوم، هذه المهن لم تعد سوى ذكريات في أذهان كبار السن، ومشاهد في الأعمال الفنية. كل مهنة منها كانت عالماً قائماً بذاته، بشخصياته وحكاياته وأسراره. دمشق الحديثة تبنى فوق أنقاض تلك المهن، لكن هل بنينا ذاكرة تكفي للحفاظ على روح المدينة؟
السؤال الأهم: أليس في كل مهنة منقرضة جزء من روح دمشق قد رحل؟ وأي مدينة سنورث لأحفادنا إذا كنا قد بعنا حتى ذاكرتنا في سوق النسيان؟