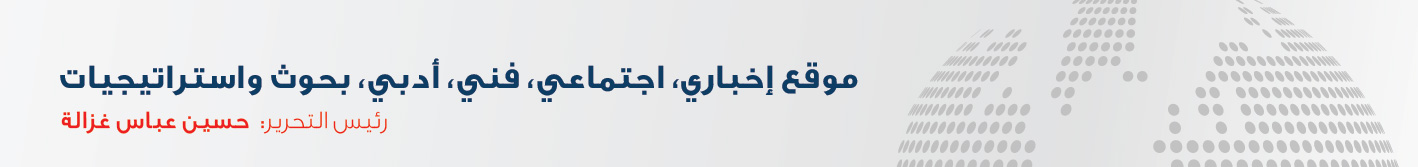في زحمة الضوء والسرعة، يرنّ هذا السؤال كجرسٍ يعيدنا إلى ذواتنا:
هل سيأتي يومٌ لا يعرف فيه الطفل كيف يُقلّب صفحة كتاب؟
هل ينتهي عصر الورق كما انتهى زمن الرسائل المكتوبة بخط اليد؟
أم أن الكتاب، كالكائن الحي، يغيّر جلده ليبقى؟
ليس السؤال عن الورق فحسب، بل عن علاقة الإنسان بالمعرفة، بالزمن، وبذاته.
فحين نتأمل كيف يقرأ أولادنا اليوم، ندرك أننا لا نفقد الكتاب وحده،
بل نفقد طريقةً كاملة في التفكير والشعور.
1. الكتاب: ذاكرة الإنسان الأولى
منذ أن خطّ الإنسان رمزه الأول على الصخر، كان يبحث عن الخلود عبر الكلمة.
الكتاب هو الامتداد الطبيعي لوعي الإنسان، الذاكرة التي حفظت القصص والعلوم والدين والأساطير.
في بيوت الأمس، كان الكتاب ضيفًا مقدّسًا: يُفتح على ضوء القنديل، ويُهدى كأغلى الهدايا.
لم يكن الورق مجرّد مادة، بل مكانًا للسكينة، وللتأمل، وللبطء الجميل.
حين يفتح القارئ كتابه، ينسحب من ضجيج العالم، يترك الهاتف والأخبار،
ويجلس وجهًا لوجه أمام فكرة، كأنها مرآة تعكس داخله.
تلك اللحظة التأملية هي ما يصنع الإنسان القارئ،
لا المعلومة التي يكتسبها فحسب، بل الوعي الذي تنقله إليه الكلمة.
2. حين تحوّلت الصفحة إلى شاشة
تغيّر كل شيء.
لم نعد نحمل الكتب في حقائبنا، بل نحملها في هواتفنا.
نقرأ ونحن ننتظر، أو نسترخي، أو نحاول الهروب من صمت اللحظة.
انتصرت ثقافة السرعة على ثقافة التأمل،
وصارت المعرفة تُستهلك كما تُستهلك الأخبار: موجزة، عابرة، بلا أثر.
في الظاهر، يبدو ذلك تقدمًا؛
فالمعلومة باتت متاحة للجميع.
لكن في العمق، انكسر شيء جوهري في علاقتنا بالكلمة.
تحوّلت القراءة من فعلِ إنصاتٍ وتفرّغٍ إلى فعلِ استهلاكٍ سريع.
صرنا نقرأ لننتهي، لا لنتغيّر.
وسرقت وسائل التواصل الاجتماعي ما تبقّى من وقتنا وهدوئنا.
تسلّلت إلى ساعاتنا، فبدّلت دفء الكتاب بسيلٍ من المقاطع السريعة،
نقلبها بكسلٍ كما نقلب قنواتٍ لا نعرف لماذا نتابعها.
استبدلت تلك المنصّات عمق الفكرة بلحظة تسلية،
وهدوء الصفحة بوميضٍ عابرٍ يختفي قبل أن يترك أثرًا.
هكذا ضاعت منا لذّة البطء، وسُرقت ساعات التأمل،
واستُبدلت المعرفة بالتمرير، والقراءة بالفرجة.
ومع ذلك، كلما شممتُ رائحة كتاب، ترتسم على وجهي تلك الابتسامة العجيبة التي لا أعرف سرّها.
ما هذا السحر الذي تسكنه رائحة الحبر وملمس الورق؟
شيءٌ يشبه العودة إلى بيتٍ قديمٍ في الذاكرة،
أو لقاءَ صديقٍ غاب طويلًا ثم عاد كما كان، بلا تغيير.
إنها نشوة لا تشبه إلا دفءَ الأمس، حين كانت المعرفة تُلمَس بالأصابع،
لا تُمرَّر على شاشةٍ باردة.
3. الطفل بين الورق والرقمية
جيل أولادنا لم يختر هذا العالم، بل وُلد فيه كما نولد نحن في الهواء.
منذ لحظاتهم الأولى، تُحيط بهم الشاشات: الهاتف، التلفاز، الأجهزة اللوحية، والمدرسة الرقمية.
يتعلمون أن المعلومة تأتي بضغطة زر، وأن لكل سؤال جوابًا فوريًا.
لكن المفارقة أن الطفل الذي يقرأ من الشاشة يحصل على المعلومة دون أن يعيش تجربة المعرفة.
الكتاب لا يمنحنا ما نعرفه فقط، بل يعلّمنا كيف نفكر فيما نعرف.
القراءة الورقية تبني في الذهن صبرًا، وترتيبًا، وترابطًا في الفكرة،
بينما القراءة السريعة تُربي ذهنيةً مشتتة لا تعرف التركيز ولا المقام الطويل في فكرةٍ واحدة.
ما زلتُ أذكر كيف كان البحث عن المعلومة في زمننا أمرًا شاقًا وجميلًا في آنٍ واحد.
حين تُطلب منّا معلومة في المدرسة، كنّا نشدّ الرحال إلى المكتبة،
نفتّش بين الرفوف، نقلب الكتب صفحةً صفحة، نلاحق فكرة واحدة وسط بحرٍ من الحروف.
كان الطريق إلى المعرفة طويلًا، لكنه ممتع؛
لأننا كنّا نغوص فيه بأنفسنا، لا ننسخ الإجابة، بل نكتشفها.
ذلك الجهد الصغير للوصول إلى الحقيقة كان يمنحنا فرحة الاكتشاف،
فرحة أن نعرف لأننا سعينا، لا لأننا وجدناها جاهزة.
وأشعر بسعادةٍ لا تُوصَف حين أرى أبنائي يقلّدونني في القراءة.
يحملون كتبهم الصغيرة بجانبي، أو يطلبون منّي أن أشتري لهم كتبًا جديدة.
تلك اللحظة تعني لي أكثر مما أستطيع وصفه؛
كأنني أرى البذرة تنبت من جديد.
أحاول أن أنقل إليهم هذا الإرث الجميل:
أن المعرفة ليست واجبًا مدرسيًا، بل رحلة دفءٍ تربطنا بالعالم وبأنفسنا.
4. مسؤولية الأسرة والمدرسة
القراءة لا تُولد بالفطرة، بل تنمو بالقدوة.
حين يرى الطفل والده يقرأ، أو يسمع أمه تتحدث بشغف عن كتابٍ أثّر فيها،
حين ينام على صوت قصة تُروى له لا على ضوء شاشة،
حينها يتكوّن داخله ذلك الرابط الأول مع الكتاب.
لكن كثيرًا من الأهل يطالبون أبناءهم بالقراءة
بينما لم يفتحوا هم كتابًا منذ زمن.
كيف سيحبّ الطفل ما لا يراه يُحَب؟
وكيف سيقدّس الكتاب في بيتٍ بلا كتب؟
أما المدرسة، فعليها أن تُعيد للقراءة معناها الحقيقي.
حين يُقدَّم الكتاب كواجبٍ مدرسيٍّ ثقيل، يفقد سحره.
يجب أن نعيد تعريف القراءة في وعي الطلاب لا كفرضٍ أكاديمي،
بل كنافذةٍ نحو الحرية والتفكير والحلم.
5. التكنولوجيا ليست العدو
ليس المطلوب أن نحارب الشاشات، بل أن نوازن بينها وبين الورق.
لكل وسيلة لغتها ومكانها.
الكتاب الإلكتروني فتح الأبواب لمن لا يملكون مكتبات،
والكتب الصوتية أعادت القراءة لمن لا يملكون وقتًا،
والمحتوى الرقمي جعل المعرفة أكثر انتشارًا وعدالةً من أي وقتٍ مضى.
لكن الخطر في أن نستسلم لسهولة الوصول ونفقد صعوبة العمق.
التكنولوجيا تمنحنا الأدوات، لكنها لا تزرع فينا الدهشة.
والدهشة هي قلب القراءة
أن نقرأ لا لننجز، بل لنندهش، لنتأمل، لنكتشف جمالًا خفيًّا بين السطور.
6. من يقرأ اليوم؟ ولماذا؟
في عصر الصورة، أصبحت القراءة فعل مقاومة.
أن تجلس بصمتٍ مع كتاب يعني أنك تختار أن تبقى إنسانًا في عالمٍ يسرق إنسانيتك كل لحظة.
أن تقرأ يعني أن تؤمن أن الأفكار تحتاج وقتًا لتنضج،
وأن المعرفة لا تُختصر في ملخصٍ أو فيديو قصير.
القراءة اليوم ليست ترفًا، بل حاجة روحية.
فهي تذكّرنا بالبطء في زمن السرعة، وبالتركيز في زمن التشتت، وبالإنصات في زمن الضجيج.
ولعل السؤال “هل أولادُنا آخر جيلٍ يحمل الكتاب؟”
ليس سؤالًا عنهم، بل عنّا نحن:
هل ما زلنا نحمل الكتاب كما يجب؟
هل نقرأ لنفهم، أم لنبدو مثقفين؟
هل ما زال الكتاب نافذةً على الذات، أم تحوّل إلى قطعة زينة على رفٍّ مهجور؟
ومضة ساخرة قبل أن نُغلق المقالة
ولعلك الآن أيها القارئ العزيز تبتسم ساخرًا وتقول في نفسك:
“جميل هذا الكلام، لكنك تكتب كل هذا على موقع إلكتروني!”
وأعترف بأن المفارقة مغرية حقًا: أن أدافع عن الورق من خلف شاشة مضيئة.
لكن ربما في ذلك شيء من العدالة الكونية؛
فإن كانت التكنولوجيا قد أخذت منّا الكتاب الورقي،
فها هي الآن تمنحنا فرصة أن نُعيد إليه الحياة بوسيلتها الخاصة.
ربما لا بأس أن نتحدث عن الحبر بالحبر الرقمي،
ما دام الهدف واحدًا: أن نبقي القراءة حيّة، كيفما كانت الصفحة.
الكتاب لا يموت، بل يُبعث من جديد
قد لا يحمل أولادُنا الكتاب الورقي كما حملناه،
لكنّهم سيحملون جوهره بطرقٍ أخرى.
قد يقرأون على شاشةٍ مضيئة، لكن سيأتي يومٌ يشعرون فيه أن الضوء لا يكفي،
فيعودون إلى الورق كما يعود العطشان إلى النبع.
الكتاب لا يموت.
إنه ينتقل من يدٍ إلى أخرى، من شكلٍ إلى آخر، من جيلٍ إلى جيل.
وما دام فينا إنسانٌ يبحث عن نفسه بين السطور،
فلن يكون هناك آخر جيلٍ يحمل الكتاب،
بل جيلٌ جديد يعيد اكتشافه بطريقته، وبصوته، وبروحه.
بقلم رئيس التحرير/ حسين عباس غزالة